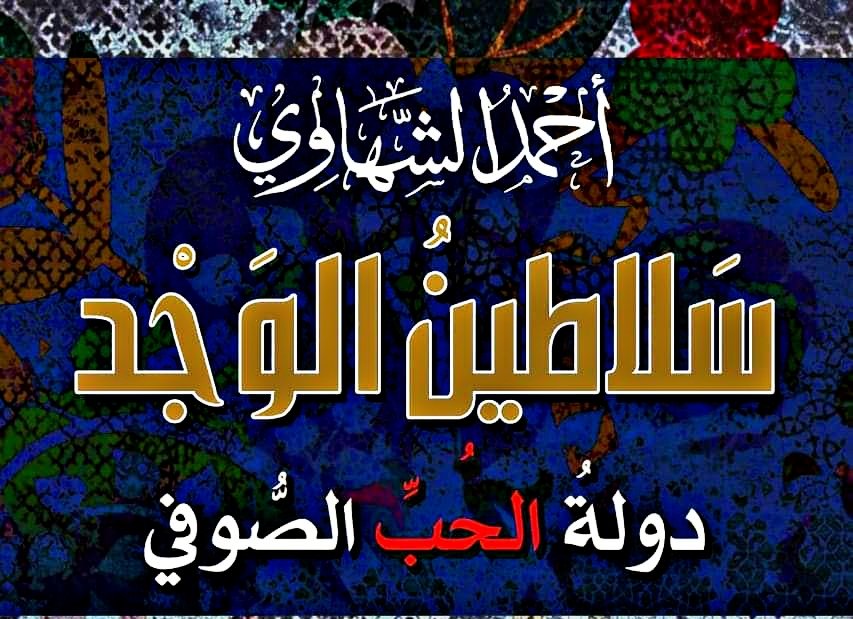أعلن الكاتب والشاعر المصري أحمد الشهاوي عن قرب صدور أحدث كتبه بعنوان “سلاطين الوجد، دولة الحب الصوفي”، عن الدار المصرية اللبنانية، ويتعاون للمرة الأولى في تصميم الغلاف مع الفنان وائل حمدان ابن العلامة محمد حمدان. وننشر مختارات من الكتاب:
1
استحق المتصوفة لقب ( السلطان ) ؛ لأنهم سلاطين زمانهم، ولأن كل سلطان صوفي يرى نفسه سلطان زمانه ، أو هو بالفعل هكذا ، فقد وقع الصدام بينهم وبين ” سلاطين السياسة ” من الخلفاء والحُكَّام والأمراء ، ولذا عاش سلاطين الصوفية تحت سيف هؤلاء المتسلِّطين ، فكانت النتيجة المباشرة أنَّ منهم من قُتِل، ومنهم من سُجِن، ومنهم من نُفِي ، ومنهم من عُذِّبَ وأُهِين ، وقد كان أوائل الصوفية ينفرُون من السَّلاطين والأمراء ، وأنا هنا أقدِّم ثلاثةً من سلاطين الوجْد، عشتُ معهم زمنًا ممتدًّا من حياتي ، ومع آخرين أثَّرُوا فيَّ ، وأثْرُوا تجربتي ، وسأخصِّص لهم كتبًا ، وأنا لا أكتبُ عن مُتصوفةٍ أحبُّهم بقدر ما أكتبُ عن أهلٍ لي ، كان لهم فضلٌ كبيرٌ عليَّ منذ صِباي في قريتي كفر المياسرة ؛ حيث سلكتُ الطريقَ الصُّوفيَّ في سنٍّ مبكِّرة، والمتصوفة الثلاثة محور هذا الكتاب هم : ذو النون المصري ، وأبو بكر الشبلي ، والنفَّري، الذي عاصر المتنبي وتوفي معه في سنةٍ واحدةٍ هي 354 هـجرية /965 ميلادية، رأيتُ أنهم كانوا سلاطينَ في زمانهم ، ولهم سطوةٌ رُوحية على من عاصرهم . وكانت كلمتهم مسموعةً عند الناس ؛ لأنهم لم يتقرَّبوا من سلطانٍ جائرٍ ظالمٍ ، ولم يتربَّحوا منه.
إنهم أربابُ الحقائق ، وليسوا من ” أهل الظَّاهر” أو” أهل الرُّسُوم ” ، إنَّهُم ” رجال قطعهم الله إليه وصانهم صيانة الغيرة عليهم ؛ لئلا تمتد إليهم عين فتشغلهم عن الله . لقد انفردوا مع الله راسخين لا يتزلزلون عن عبوديتهم مع الله طرفة عين ” بتعبير محي الدين بن العربي ، الذي كان من ضمن أسمائه ” سلطان العارفين ” ، مثلما كان اسم عمر بن الفارض ” سلطان العاشقين ” .

كتاب الشاعر أحمد الشهاوي- سلاطين الوجد دولة الحب الصوفي
2
ما الحُبُّ العذريُّ إلا تصوفٌ أو طريقٌ إليه .
وما الحُبُّ إلا مقامٌ إلهيٌّ ؛ لأنَّ ” المحبة هي أصلُ جميع المقامات والأحوال ” ، و”أكمل مقامات العارفين ” .
وفي الحُبِّ يُعوِّل المرءُ على القلبِ أكثر مما يُعوِّل على العقلِ الذي قد يمثل حجابًا كثيفًا على الذات حين تفكِّر والرُّوح حين تشتغلُ ؛ فالحب يهتك ما استتر، ويكشفُ ما هو مخبوءٌ ، أو ما هو سريٌّ .
و الذات العليا للإله تتمثل في الحب. وبالمحبة يقتربُ الإنسانُ من الله .
وأنا أحاول مع الشَّاعر الروماني فرجيل ( 15 من أكتوبر 70 قبل الميلاد – 21 من سبتمبر 19 قبل الميلاد ) أن أقول في هذا الكتاب : (الآن أجدني أعرف ما هو الحب ؟).
والحُبُّ الصُّوفيُّ هو أصلُ وجود الحُبِّ في العالم ؛ لأنه مظهر للحب الإلهي ؛ لأن الحُبَّ بطبيعته “أصل الموجودات ” ، الحُب المنبثق من الحقيقة والباطن، والمحبة هي من أعمال الباطن، والمتصوفة هم أهل المحبة وينسبون إليها . والحب عند المتصوف هو أسلوب حياة ، ودليل المعرفة الصوفية التي تعكس حال القلوب السامية.
وبالحب – الذي هو منحة إلهية – يستطيع من يحبُّ أن يصل إلى الحقيقة المطلقة التي يريدها ويسعى إليها ، ليسكن النقطة الأعلى من فردوسِ الرُّوح .
والنبي محمَّد يقول : ” جُبِلت القلوب إلى حبِّ من أحسن إليها ” .
3
يسلك الشَّاعر الصُّوفي طريق المعرفة، ولا يرى طريقًا غيرها ؛ ليعبِّر عن بواطنه وأشواقه، حين يكون في مقام الإشراق، إذْ إنَّ نصوصه نشيدٌ طويلٌ للعشق، والجمال المطلق.
ويعيش الشَّاعر حياته متقشفًا زاهدًا قانعًا بما اصطادت روحه في حياته ، ونصِّه ، حيثُ لا يبحثُ عن منصبٍ أو جاهٍ ؛ لأنه باع كل ذلك في سبيل أن يكون سالكًا في طريقٍ رُوحيةٍ شائكة وشائقة ، وطويلة مداها ، يمضي في مدارج التجريد ، ذاهبًا نحو أودية المستضعفين ، الفَّارِّين من زحام التكالُب والتخالُّب على عظام الحياة العارية.
كما يعيش في مقامٍ خاصٍّ ، معتزلا ، منتظرًا فتحًا وكشفًا وفيضًا تترادف ولا تنقطع ، إذ إنَّ شِّعرَ الصوفي نسخةٌ من مواجيده، يُعبِّر به عن رؤاه ، أو هو صورة شعرية لنثره الفكري ، ونظره إلى الوجود والحقيقة ، يبتعد عن التصنُّع والتكلُّف .
وإذا كان الشاعر الصوفي من ذوي الكشف، يرى فناء نفسه في حالة سُكرٍ ووجْدٍ، فهو ابنٌ للشَّطح، الذي ليس وهمًا ولا تخيُّلا، بل صار هو المرآة ، وهو أبعدُ زمنًا من تلك النظرة الضيِّقة التي يراها كارهو التصوُّف والصوفية ، وهو قوتُ الشاعر وزاده كمسافرٍ في الأزمنة والأمكنة ، خُصوصًا ذاته التي هي المصدر ، والمكان الأول الذي يحتضن كل كلمة تُولد، فشطح الشاعر من قوة وجْدِه، وفيضان بحره، حتى لا يعود يطيق (ما يردُ على قلبه من سطوة أنوار حقايقه) .
الشاعر الصوفي هو – إذن – المُتحرِّر من رقِّ الأغلال، الناطق عن سرِّه، لأن ” النقش هو النقّاش “، في يديه جِنان الفردوس، وجنون جحيم الشطح ، فهو كاشفٌ للحقيقة المطلقة ، التي تتجلى في العرفان الوجداني والمعرفة الذوقية واللدنية .
التي يعتبرها بيان عشقه واتصاله ، ووصله بمن يعشق .
ويُودِع الشاعر العارف سرَّه في نصه ، معتمدًا مبدأ الذوق والمعرفة ، أي ( مَن ذاق عَرَف ، ومَن عَرَف اغتَرَف) ، ولا يمكن أن يتحقَّق ذلك إلا عبر ظاهر الأشياء ، ولكنه يُعوِّل على الباطن ، باطن المحبة باعتبارها مقام الشاعر الأعلى مكانةً ومرتبةً ، حيث يمحو من قلبه ما سوى محبوبه ، الذي يستولي ذكره على كُلِّه ؛ حتى لا يبقى منه شئ لغير من يعشق .
والشاعر السَّكران بخمرةٍ رُوحية ، تلك الخمرة الرامزة إلى العشق المُقدَّس ، والتي هي أزليةٌ تشربها الروح فتنتشي وتثمل ، حيث تسكر العقول ” بما يُلقَى إليها من العلوم والحقائق العرفانية ” .
والحُب – الذي فيه أُنس القلب – هو هِبةٌ ، ومنَّةٌ ، وعطيَّةٌ ، ورزقٌ ، ومُصادفةٌ إلهيةٌ ، وليس كسبًا ، يمكنُ للمرء أن يحصده ، أو يتحصَّل عليه ، لكنه بذرةٌ تسقيها السَّماء بمائها ؛ حتَّى تكبر ؛ لتصيرَ شجرةَ عشقٍ ومعرفةٍ .
ويعيش الشاعر الصوفي حياته تحت سقيفةٍ من الرموز والإشارات، لأنه يذهب بلغته إلى ما وراء اللغة، ولذا لا يفقهه الكثيرون، ومن ثم يتهمه أصحاب الظاهر ، وأهل النظر الضيِّق بالكُفر والزندقة، حتى أن كثيرين من أهل الإشارة ، وأصحاب الوقت والحال قد اضطهدوا ، أو سِيقوا إلى القتل ، أو سُجنوا وضُربوا وعُذِّبوا ، لأنهم لم يستطيعوا كتمان الأسرار على العامة والخاصة أيضًا .
فالشاعر الصوفي الذي يذهب إلى ما وراء الأشياء والمحسوسات، مقتصدٌ ، لفظه قليل، ومعانيه كثيرة، بعيدة عن ظاهر لفظه ، يختصر ، ويوحي، ويلوِّح، ويُلمِح، ويشير، ويرمز، كي يدل على جوهر باطنه.
ولأن باطن الشاعر الصوفي يحكمه الذوق والوجد ، ولا يمكن للظاهر أن يحاكمه ، فقد ظل في نصوصه الشعرية والنثرية – على مدار التاريخ الإسلامي – محرومًا من العيش في طمأنينة ، ومطرودًا من رحمة الحُكَّام والوُلاة والأمراء والخُلفاء والفُقهاء من عُدماء الدين وجهلته ، وما أكثرهم في كتاب تاريخنا .